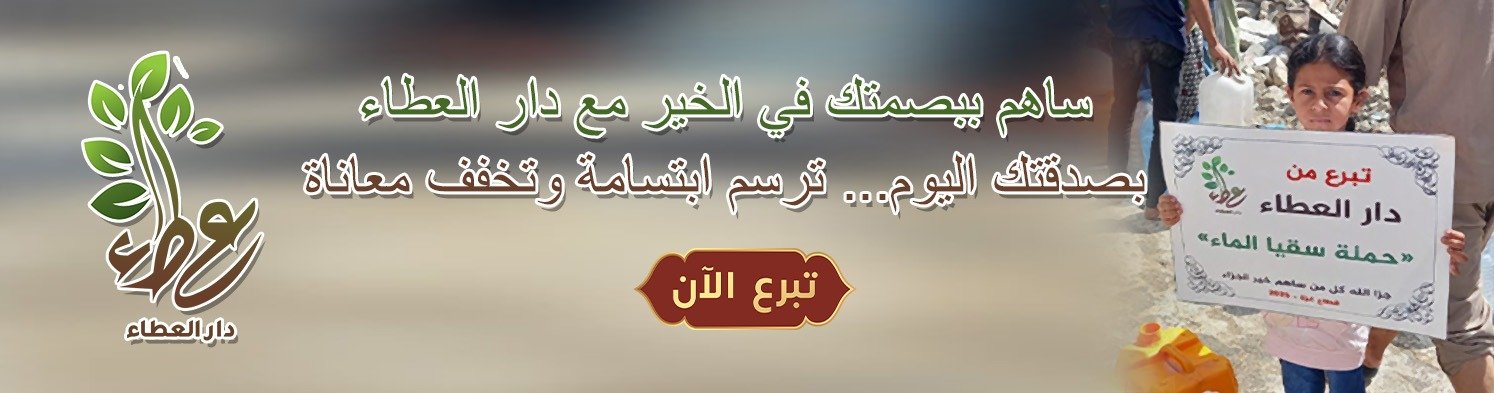الطائفة القرائية بين الرفض الحاخامي والاستقلال العقدي عبر التاريخ

نشأت الطائفة القرائية في لحظة توتر فكري وروحي. وفي تلك اللحظة ظهر اختلاف عميق حول مصدر التشريع الديني. فبينما تمسّك الربانيون بالتقاليد الشفوية. رفض القراؤون تلك المرجعية بشكل قاطع. وهكذا بدأ مسار فكري جديد. ثم بدأت ملامح مذهب مستقل بالتشكل التدريجي. ومع ذلك ظل الجدل محتدمًا بين الطرفين لقرون طويلة. الطائفة القرائية لم تكن مجرد انشقاق ديني عابر. بل كانت مشروعًا فكريًا يعتمد النص دون وسيط. كما سعت إلى تحطيم سلطة التفسير الموروث. ومن هنا وُلدت أزمة الاعتراف والهوية. ثم تحوّلت الطائفة إلى نموذج ديني مختلف. إذ جعلت التوراة المكتوبة أساس كل حكم. وفي المقابل رفضت التلمود والمشنا بشكل صريح. وبذلك دشّنت نهجًا فرديًا في القراءة والفهم. وعلى الرغم من قلة عدد أتباعها. إلا أن تأثيرها الفكري كان واضحًا. وذلك لأنها خلقت حالة تمرّد على السلطة الدينية. ثم فتحت المجال أمام العقل والتحليل المستقل. وبالتالي باتت الطائفة القرائية محل جدل دائم. كما أصبحت مرآة لصراع النص والتفسير. وهكذا استمر وجودها عبر قرون متعاقبة. حتى وصلت إلى العصر الحديث بهوية متماسكة.
أولًا. جذور الطائفة القرائية في العراق
بدأت القصة في القرن الثامن الميلادي. وفي تلك الفترة شهد العراق نشاطًا دينيًا كثيفًا. ثم ظهر عنان بن داود كقائد فكري. فدعا إلى العودة للنص وحده دون وسيط. وبذلك رفض الاعتراف بالحاخامية السائدة. كما رفض الخضوع للتفسير الشفهي. فأصبح معارضًا للسلطة الدينية الرسمية. وهنا بدأت أولى مراحل الصدام. ثم دخل السجن بأمر سياسي وديني. لكن أثناء ذلك التقى الإمام أبا حنيفة. ومن خلال الحوار تبلورت لديه أفكار جديدة. ومن ثم تأثر بمفهوم القياس العقلي. وهكذا خرج عنان بفكر أكثر نضجًا. ثم بدأ تدوين أفكاره في مصنفات. وكان أبرزها كتاب الأوامر والنواهي. وبذلك انطلقت الطائفة بهوية واضحة. ثم تجمّع حوله أتباع كثر. لأنهم رأوا فيه صوتًا للتحرر. ولأنهم رفضوا سيطرة الحاخامات. ومن هنا انتشرت الفكرة بسرعة.
ثانيًا. مفهوم النص المقدس عند القرائين
ترتكز الطائفة القرائية على مبدأ أساسي. وهو أن التوراة المكتوبة مصدر وحيد للتشريع. ولا وجود لأي نص مقدس آخر بعدها. لذلك يرفضون التلمود رفضًا مطلقًا. ويرون أنه اجتهاد بشري لا قدسية له. كما يعتبرون المشنا نصًا تفسيريًا فقط. وليس حكمًا ملزمًا من السماء. وبالتالي يتحرر القارئ من سلطة الحاخام. ثم يعتمد على نفسه في القراءة والتأويل. وهنا يظهر دور العقل بوضوح. بل يصبح الفهم مسؤولية فردية. لكن مع ذلك لا يلغي القراؤون أهمية التفسير. بل يدعون إلى تفسير قائم على النص وحده. ثم يحذرون من تراكم الأخطاء البشرية. ولهذا يشددون على العودة للأصل دائمًا.
ثالثًا. شعار الطائفة القرائية
تعتمد الطائفة القرائية شعارًا ثابتًا. وهو: ابحث بعناية في التوراة. وهذا الشعار ليس مجرد عبارة. بل هو منهج حياة كاملة. إذ يدفع الفرد لقراءة النص بتمعّن. ثم يدفعه للتفكير النقدي المتوازن. وفي المقابل يرى الربانيون خطر هذا الشعار. لأنه يلغي دور المؤسسة الدينية. ولأنه يشجّع الاجتهاد الفردي. وهنا يكمن جوهر الخلاف. ومع ذلك استمر القراؤون في رفعه. ثم جعلوه أساسًا لعقيدتهم التربوية. فاغتدى التعليم عندهم ضرورة قصوى. وأصبح كل فرد قارئًا ومفسرًا.
رابعًا. الهجوم الرباني على القرائين
قاد الحاخام سعديا جاؤون الحملة الفكرية. فهاجم الفكر القرائي بكل قوة. وقال إن النص لا يُفهم دون تفسير شفوي. ثم حذّر من أن الفكر القرائي يسبب الانقسام. واعتبره مدخلًا للفوضى الدينية. كما وصفه بالمخالف للإرادة الإلهية. وبذلك اشتد الصراع بين الطرفين. لكن رغم هذا الهجوم استمر القراؤون. ثم أسسوا مدارس خاصة بهم. وانتشرت أفكارهم في مناطق عدة. ومنها فلسطين ومصر والقسطنطينية. وهكذا صمدت الطائفة أمام الضغوط. بل ازدادت تمسكًا بمبادئها. وهذا يدل على عمق الإيمان بنهجهم.
خامسًا. انتشار الطائفة القرائية عبر العصور
شهدت القرون الوسطى ازدهارًا ملحوظًا. إذ نشط القراؤون في العلوم واللغة. كما برزوا في التفسير والأدب. ثم انتقلوا إلى بلاد الشام ومصر. وبنينوا مراكز لهم في القدس. لكن بعد تحرير القدس تراجع النفوذ. ثم انتقل مركز الثقل إلى مناطق أخرى. وفي روسيا وأوروبا ظهر تيار قومي قرائي. حيث ادعوا أنهم ليسوا يهودًا عرقًا. وكان الهدف الهروب من الاضطهاد. وهكذا تشكّلت هوية مزدوجة. وفي المقابل ظهرت جماعة ناعين إلى صهيون. فدعت إلى العودة إلى القدس للعبادة. ثم ربطت العقيدة ببناء الهيكل. وهو ما أثار جدلًا جديدًا.
سادسًا. العلاقة مع الكيان بعد 1948
بعد إعلان قيام إسرائيل بدأت هجرة واسعة. وانتقل معظم القرائين إلى الداخل الجديد. وكانت الهجرة على ثلاث مراحل رئيسية. ثم عُين الحاخام إيمانويل قائدًا رسميًا. وتركز القراؤون في مدينة الرملة. وبنوا معابد في أسدود والقدس. وفي عام 1963 أسسوا جمعية عالمية. ثم سجلت رسميًا لاحقًا في القانون الإسرائيلي. وكان هدفها توحيد أبناء الطائفة. إضافة إلى دعم التعليم والثقافة. ومن جهة أخرى بقي الاعتراف الرسمي غائبًا. إذ لم تُمنح الطائفة صفة دينية مستقلة. وهنا استمر الإحساس بالتهميش.
سابعًا. دلالة اسم الطائفة القرائية
اشتُق الاسم من كلمة قرائيم. والتي تعني أهل القراءة. وهي تشير إلى التمسك بالنص المكتوب. كما يُعرفون باسم أبناء المقرا. أي أصحاب التوراة المكتوبة. وأحيانًا يُطلق عليهم العنانيون. نسبة إلى مؤسسهم عنان بن داود. وهذا التعدد في الأسماء يعكس الهوية. كما يعكس محاولات تصنيفهم دينيًا. لكنهم يفضلون اسم القرائين. لأنه يعبر عن جوهر منهجهم.
ثامنًا. رؤيتهم للتوراة والأنبياء
يرى القراؤون أن الأسفار الخمسة مقدسة. وكذلك كتب الأنبياء المعترف بها. أما بقية الأسفار فهي تاريخية فقط. وبالتالي لا تُستخدم للتشريع. بل تُقرأ للعظة والعبرة. وهذا يميز منهجهم عن غيرهم. كما يؤكدون أن الله لم يفسر التوراة. لا شفهيًا ولا كتابيًا. وترك الفهم للعقل المؤمن. وهنا يظهر البُعد الفلسفي.
تاسعًا. العبادات والطقوس عند الطائفة القرائية
تختلف العبادات القرائية عن الربانية بوضوح. وذلك بسبب اختلاف مصدر التشريع. فكل طقس مرتبط مباشرة بالنص. ولا وجود لأي إضافة بشرية. الصلاة عندهم تعتمد على المزامير. وكذلك على أدعية مأخوذة من التوراة. ولا يستخدمون الصلاة الربانية المعروفة. بل يضعون لكل مناسبة نصًا خاصًا. وهم لا يعترفون بتوقيتات حاخامية. بل يحددون الأوقات حسب رؤية القمر. وحسب فهمهم المباشر للنصوص. وهنا يبرز عنصر الاستقلال الكامل. ثم يعتمدون على السجود الكامل. كما ورد في التوراة حرفيًا. فيضعون وجوههم على الأرض. وهو أمر غائب عند غيرهم. وهذا السجود يعبر عن الخضوع الخالص. ويعكس مدى التزامهم الحرفي. كما يمنح طقوسهم طابعًا فريدًا.
عاشرًا. السبت في الفكر القرائي
يوم السبت يعتبر مقدسًا للغاية. لكن تفسير قدسيته يختلف جذريًا. فهم يمنعون إشعال أي نار. حتى لو كان الجو باردًا. كما لا يخرجون من منازلهم. ولا يؤدون أي عمل مهما كان بسيطًا. لأنهم يفسرون النص حرفيًا. دون أي تأويل مرن. وبالتالي يصبح السبت يوم سكون كامل. لا حركة فيه ولا نشاط. وهذا يضعهم في عزلة اجتماعية كاملة. لكنهم يرون ذلك طاعة خالصة. وفي المقابل يرى الربانيون أنهم متشددون. لكن القرائين يرون أنهم الأصدق التزامًا. وهنا يظهر التباين بوضوح.
حادي عشر. الطعام وأحكامه
يعتمد القراؤون على النص فقط. لذلك تختلف أحكام الطعام لديهم. فهم لا يعترفون بالذبح الحاخامي. بل يكتفون بالشروط المذكورة فقط. كما يمتنعون عن بعض الأطعمة. التي يسمح بها الربانيون. لأنهم لا يجدون نصًا واضحًا عليها. وهذا يعكس تشددًا نصيًا. وفي المقابل قد يأكلون أشياء. يمتنع عنها غيرهم من اليهود. لأنهم لا يرون فيها تحريمًا صريحًا. وهكذا يختلف المعيار جذريًا. ويُلاحظ أنهم أكثر بساطة. ولا يدخلون في تفاصيل دقيقة. بل يحصرون أنفسهم في حدود النص.
ثاني عشر. الزواج والطلاق
الزواج في الطائفة القرائية نصي خالص. لا يدخل فيه تفسير التلمود. بل يعتمد على أسفار موسى فقط. ولهذا يُسمح ببعض الأنواع. التي تمنعها الربانية. مثل الزواج من الأرملة دون طقوس إضافية. لعدم وجود نص مانع. أما الطلاق فيتم بشروط صارمة. تشبه ما ذُكر في النص القديم. ويشترط فيه العدل الواضح. وإلا يعد باطلًا. وتُمنح المرأة مكانة واضحة. لأنهم يستندون مباشرة للنص. ولا يعتمدون على تفسيرات ذكورية. وهذا منحهم صورة متميزة.
ثالث عشر. التعليم واللغة
اهتم القراؤون باللغة العبرية بشدة. واعتبروها مفتاح فهم النص. ولهذا أسسوا مدارس للغة. وكان لهم دور كبير في تطوير قواعدها. وبرز منهم علماء في النحو. مثل يافيت بن علي. وغيره من المدرّسين. كما ركزوا على التعليم الفردي. فكان كل أب يعلّم أبناءه القراءة. حتى يتمكنوا من فهم التوراة. وهذا خلق مجتمعًا قارئًا فعلًا. وكان التعليم عندهم عبادة. وليس مجرد وسيلة علمية. وهذا ما رفع مستواهم الثقافي.
رابع عشر. الصراع حول الهوية
ظل سؤال الهوية عالقًا لقرون. هل هم يهود أم فرقة مختلفة. هل هم اتباع توراة فقط. أم أمة مستقلة دينيًا. الربانيون رفضوا الاعتراف بهم. وحرّموا الزواج منهم. وأعلنوا أنهم خارج الجماعة. وهذا زاد الانقسام. لكن القرائين لا يرفضون اليهود. بل يرفضون التفسير الشفهي فقط. ويرون أنفسهم الأصل. بينما يرون الربانيين مبتدعين. وهذا الصراع كان فكريًا دائمًا. لكنه لم يتحول إلى صراع دموي. بل بقي في دائرة الكتب. والمجادلات والمناظرات.
خامس عشر. الحضور في العصر الحديث
اليوم يوجد قراؤون في عدة دول. منها إسرائيل وتركيا وأوكرانيا. كما يوجد حضور محدود في أمريكا. ويقدّر عددهم بعدة عشرات الآلاف. ولكنهم يحافظون على هويتهم. من خلال جمعيات خاصة بهم. ومدارس دينية مستقلة. وفي إسرائيل يطالبون بالاعتراف. كمذهب يهودي رسمي مستقل. لكن الطلب لا يزال معلقًا. وهذا يعيد أزمة الهوية من جديد. كما يستخدمون الإنترنت في الدعوة. وينشرون كتبهم إلكترونيًا. وهذا أعاد إحياء اهتمام الباحثين.
سادس عشر. أثر الطائفة القرائية فكريًا
رغم قلة العدد. إلا أن الأثر كبير. لأنهم مثّلوا تيارًا نقديًا. كسر احتكار المؤسسة الدينية. وشكّلوا سابقة تاريخية. في رفض السلطة الدينية المطلقة. وفتحوا الباب للاجتهاد الفردي. في كل الديانات لاحقًا. ولهذا يهتم بهم الباحثون. في علم الأديان المقارن. ويرون فيهم نموذجًا فريدًا. للفصل بين النص والتفسير.
سابع عشر. جدلية الحرية والالتزام
يظن البعض أنهم أكثر تحررًا. لكن في الواقع هم أكثر التزامًا. لأن النص عندهم صارم. ولا يقبل التلاعب. ومع ذلك يمتلكون حرية عقلية. في طريقة الفهم والاستيعاب. وهذا خلق توازنًا نادرًا. بين الانضباط والحرية. وهنا تتجلى الفلسفة العميقة. فهم أحرار في العقل. لكنهم ملتزمون في السلوك. وهذا سرّ قوتهم.
ثامن عشر. خلاصة تحليلية نهائية
الطائفة القرائية ليست طائفة هامشية. بل هي تجربة فكرية كبيرة. في تاريخ الأديان. ظهرت نتيجة الصراع على التفسير. واستمرت بفضل الإيمان بالنص. وانتقلت عبر قرون طويلة. دون أن تذوب أو تختفي. ورغم الرفض والتهميش. احتفظت بهويتها الخاصة. وبلغتها وأساليبها وطقوسها. وهذا دليل على صلابتها الفكرية. واليوم تعود إلى الواجهة. وذلك بسبب البحث عن الأصل. وبسبب السؤال الدائم. من يملك حق التفسير. وهنا تضع الطائفة القرائية. جوابًا واضحًا أمام الجميع. هو أن النص يكفي وحده. وأن العقل هو المفتاح. وهكذا تستمر القصة. ليس كصراع ديني فقط. بل كدرس إنساني عميق. حول الحرية والهوية.
اقرأ كذلك: العلويون.. القصة الغامضة لحكم سوريا